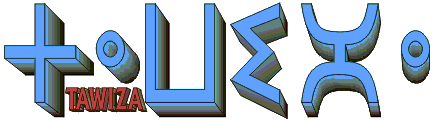|
| |
مصطلح «المغرب
العربي»وأسئلة الديمقراطية
بقلم: أيت بود محمد
كما هو معلوم دأبت وسائل الإعلام، والخطابات
الرسمية، والمقتضيات الدستورية المغاربية، على تسمية منطقة شمال أفريقيا بمصطلح:
“المغرب العربي”، فبقد رما تحيل هذه التسمية على خلفية عرقية واضحة، يثار بشأنها
التساؤل التالي: إلى حد تنسجم هذه التسمية مع متطلبات الانتقال الديمقراطي؟ خاصة في
المغرب بحكم كونه يستعمل هذا المفهوم في الخطاب السياسي الرسمي.
والأمر اللافت للانتباه، هو الاختلاف الواضح بين نفس التسمية في اللغتين العربية
والفرنسية، بحيث تكتفي هذه الأخيرة بمصطلح: “Le Maghreb»، بدون أي تصنيف عرقي، في
حين يلاحظ الإصرار الواضح للخطاب الرسمي ووسائل الأعلام، على إضافة نعت «العربي»
إلى تسمية «المغرب» الذي عرف في الكتابات التاريخية القروسطية بهذه الصيغة: «المغرب
الأقصى»، ويقصد به المغرب الحالي وموريتانيا، والمغرب الأوسط ويقصد به الجزائر
الحالية، وإفريقية ويقصد به تونس وليبيا، وتسمى منطقة شمال إفريقيا في بعض الكتابات
التاريخية بتسمية: «الغرب الإسلامي» كذلك، فمن أين جاءت تسمية: «المغرب العربي»؟
وهل بقي من مبرر لبقائها دون الالتفات إلى تاريخ المنطقة الإثني والسياسي، وواقعه
السوسيولوجي؟ ودون افتحاص مدى انسجامها مع جل مفاهيم الحداثة السياسية، من
ديمقراطية وحقوق إنسان، ومواطنة... الخ؟
الملاحظة الثانية هي اقتصار هذا اللفظ على منطقة شمال إفريقيا، بالرغم من التنوع
الثقافي واللغوي السائد بها، في حين يقتصر على تسمية منطقة الشرق الأدنى مثلا
بمصطلح:»الشرق الأوسط-Moyen Orient «، وعلى تسمية منطقة الحجاز والعراق بمصطلح: «الخليج-le
golf»، دون إضافة نعت: «العربي» مع أن المنطقتين هما المعروفتان تاريخيا بانتشار
اللغة والثقافة العربيتين وبتواجد الجنس العربي يهما منذ القدم.
سوف أحاول ان أقارب هذه الإشكالية، أي مصطلح «المغرب العربي»، ورهان الديمقراطية،
التي تتوق اليها شعوب بلدان المغارب، من خلال محاولة تتبع أصل التسمية أولا ثم مدى
انسجامها مع متطلبات الديمقراطية ثانيا.
أولا: مصطلح:»المغرب العربي»وأسئلة التاريخ والهوية:
1-المساءلة التاريخية:
لم يعد يساور العامة أدنى شك في أن هذه التسمية صائبة وتعبر عن حقيقة أن سكان شمال
إفريقيا هم عرب بالسليقة، وبتعبير آخر أي أن التسمية أصبحت من المسلمات والبديهيات
التي لم تعد تقبل النقاش وإعادة النظر، أما الخاصة فهي تعي تماما أن التسمية ضرورية
في إطار أيديولوجية الحكم المعلومة، طالما أن الأمر لا يخرج عن نطاق التسمية
بالنسبة للعامة وحسب، فبلدان المغارب التي يقول عنها الناصري في الاستقصاء «أنها لم
تكن أبدا موطنا للعرب، بل هي موطن للبربر»، لم تعد تعترف إلا بالعرب الفاتحين، أما
البربر السكان الأصليون، فقد ذابوا في هذا المجتمع الجديد وفقدوا بذلك خصوصيتهم،
أما إذا أردنا أن نستقصي عن من هو أكثر عروبة، وعن من يتشدق بالعروبة، ولا شيء آخر
غير العروبة، فإن العرب المغاربة إذا جاز هذا النعت، أو بالأصح المستعربون
المغاربة، هم أكثر عروبة من غيرهم، ولذلك تراهم يحرصون أيما حرص على ألا يكون هذا
المغرب لغيرهم، حتى من باب التسمية، إنها بداية إقصاء حقيقي سيتخذ أشكالا متعددة،
لغوية، ثقافية، سياسية واقتصادية فيما بعد.
فمن أين جاءت هذه التسمية؟ ولماذا لم تظهر إلا في العصر الراهن؟ فكما هو معلوم
فالتاريخ يؤكد بشكل قاطع، أن هذه التسمية مستحدثة، وأنها مرتبطة بالحركة القومية
العربية في المشرق أولا، ثم بالحركة الوطنية في المغارب أخيرا، فكانت النتيجة أن
الحركة الوطنية في المغرب على سبيل المثال لا الحصر التي كانت تخشى من استحواذ
المقاومة المسلحة في الجبال على الرأسمال السياسي، وبعد سحب البساط من تحت أرجلها
بواسطة «أحجية الظهير البربري»أن اخترعت هذه التسمية، لتدق بذلك آخر مسمار في نعش
المقاومة المسلحة أولا، وفي نعش طائر العنقاء الأمازيغية الراقد وسط رمضاء المقاومة
المسلحة أخيرا، وهكذا فإن أحد جهابذة القومية العربية، وهو شكيب أرسلان، هو صاحب
هذا المصطلح،هذا «الجهبذ العروبي»الذي كان يخشى كثيرا على العروبة في بلدان المغارب
من «البربرية»كما كان يخشى عليها في المشرق من التركمانية،هو الذي أوحى إلى أصحاب «تخريجة
الظهير البربري»ما أوحى، ولأنه-حسب اعتقادهم- «فالبربرية»الراقدة في رماد المقاومة
المسلحة -التي قادها الأبطال الأمازيغ في الجبال، أمثال محمد عبد الكريم الخطابي أو
«مولاي محند «،وموحا أوحمو الزياني في الأطلس المتوسط،ومحمد أمزيان في الأطلس
الكبير الأوسط، وعسو أوبسلام وزايد أوحماد في الأطلس الكبير الشرقي، خاصة قبائل أيت
عطا، وعبد الله زاكور في الأطلس الصغير- أرقت كثيرا أقطاب الحركة الوطنية،الذين
نجحوا في استغلال ظهير المحاكم العدلية- الذي أصدرته سلطات الحماية
الفرنسية،ليتحاكم بواسطة مقتضياته «البربر»في مناطق العرف،إلى جانب القانون الفرنسي
والشرع الإسلامي، بالنسبة للقضايا التي لا يوجد مقتضى بشأنها في هذين الأخيرين،
والذي صادق عليه السلطان كما صادق من قبل على مجموعة من الظهائر الأخرى التي كانت
تروم التنظيم القضائي في عهد الحماية- أقول نجحوا في استغلال ذلك الظهير لتقوية
مركزهم السياسي، وإقصاء المقاومة المسلحة التي يمثلها الأمازيغ من التفاوض مع
المستعمر، وبالتالي من نيل نصيبها من السلطة، فانطلت اللعبة على البسطاء.
نفس المنطق الإقصائي لا يزال سائدا، بيد أن التشدق بعروبة بلدان المغارب، ليس وليد
اليوم، لأنه منطق تغذى من التاريخ كثيرا، إذ الأمر لا يقتصر فقط على تسمية منطقة
بغير اسمها، وهو جزء من نفس المنطق وحسب، بل شمل هذا المنطق التحريفي التاريخ،
والطوبونيميا، والرموز الثقافية كذلك. لنلق نظرة على تاريخ المنطقة، سوف نجد أن
التحريف طال كل شيء، ولا يقتصر فقط على الكاهنة (Tihia) وكسيلة، (Aksul )،بل شمل
أيضا الممالك الأمازيغية ما قبل الإسلام، فكيف تم تصوير هذين القائدين في الكتابات
التاريخية العروبية؟ إن لم تكن هي نفس الصورة التي رسخها في عقول المؤرخين العرب،
الاستبداد الأموي، وكيف أوردهما لنا ذلك التاريخ المتحيز جدا، وغير الموضوعي جدا،
سوى أنهما وقفا في طريق نشر الإسلام في المنطقة، في حين وصف عقبة بن نافع بالقائد
العربي الذي وصل إلى تخوم بلاد البربر، وهو ينشد نشر الحنفية السمحاء !، ثم لنلق
نظرة على الطوبونيميا، مبتدئين بتسمية منطقة شمال إفريقيا، بالمغرب العربي، في
نكران تام للعنصر الأمازيغي الذي لا يزال يشكل السواد الأعظم من الساكنة بالمنطقة،
إنه منطق إقصائي تعسفي، لا يعبأ بتناقضاته الجوهرية، الانطولوجية مع ذاته، ومع
التاريخ، ومع ما ينشده من مواطنة وديمقراطية وحقوق إنسان، ثم ننتهي بالأسماء
الصغيرة، أسماء أدق التفاصيل الجغرافية في بلاد تامازغا. لقد تم طمس كل المعالم
التي تدل، والتي سوف تدل في المستقبل على وجود عنصر بشري يسمى:»البربر» في شمال
إفريقيا، والذي أثبتت الأبحاث الجيولوجية المتقدمة جدا في إحدى الجامعات الأمريكية،
أنه سكن المغارب منذ ثمانين ألف سنة، ( يتعلق الأمر بمنطقة تافوغالت بالمغرب)، وما
بقي من هذه الأسماء لا يزال يقاوم التحريف والطمس، في استماتة منقطعة النظير، وأخير
لنلق نظرة على الرموز الثقافية، خاصة الأعلام والرموز السياسية، وصناع أهم الأحداث،
والمؤثرين في صياغة أهم القرارات التاريخية المصيرية بالمنطقة، متسائلين عن مصير
القائد الأمازيغي طارق بن زياد، الذي دفع به العرب إلى ظلمات البحر المتوسط،
لاكتشاف الفردوس المفقود في الأندلس أولا قبل أن يكافئوه بالحبس والتشريد والنسيان
فيما بعد؟ (فتح طارق بن زياد شبه الجزيرة الإيبرية سنة -92هـ)، ثم مصير القائد
الأمازيغي، يوسف بن تاشفين، الذي يسميه المثقفون العرب الشوفينيون، «بالملك البربري
المتوحش»، ذلك لأنه لم يكن ملكا عربيا أولا، ثم لأنه لم يكن يعرف المداهنة
والمجاملة والمساومة، بل كان قويا وشجاعا، وواضحا في مبادئه وأهدافه، هذا القائد،
استطاع أن يوحد الأندلس بعد أن مزقها ملوك الطوائف وأن يؤخر سقوطها أربعمائة سنة،
بعد انتصاره على الفونصو السادس ملك اراكون في معركة الزلاقة سنة 479 هـ، بماذا
كافأه التاريخ العربي المنحاز والمزور، غير التهميش والنسيان، في قلب مدينته التي
أسسها واتخذها عاصمة ملكه وسلطانه بالمغرب، غير دكانة متواضعة في ركن من أركان
صومعة الكتبية، بمدينة مراكش، في حين يرقد نظيره الملك العربي- الشاعر، المعتمد بن
عباد، في قبة زاهية بمدينة أغمات، يحج إليها آلاف الزوار من الذين يحنون إلى»المجد
العربي»بالأندلس.
فما الذي كان يقصده الأستاذ محمد شفيق»بوجود عقليتين متباينتين في المغرب المعاصر
هما: عقلية يوسف بن تاشفين وعقلية المعتمد بن عباد؟»( انظر مجلة تيفاوت العدد 2)
2- أسئلة الهوية :
إذا جاز نعت المنطقة بهذا الاسم، وهو كما يبدو ذلك من صيغته اللغوية التي تحيل على
خلفية عرقية وهوياتية واضحة، تروم إلى القول أن منطقة بلدان المغارب أو منطقة شمال
إفريقيا، يسكنها شعب عربي يتكلم اللغة العربية وحسب، خشية أن ينازع هذه الهوية
منازع، فإنه يجوز نعته بأسماء متعددة أخرى، تحيل على هويات أخرى مساكنة لهذه الهوية
الإقصائية، ومجاورة لها، بل مواطنة لها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مصطلح
المغرب الأمازيغي، أو المغرب الإفريقي، فالمنطقة تعرف تنوعا لغويا وثقافيا وهذه
حقيقة لا تخفى على أولئك الذين يصرون على هذه التسمية الإيديولوجية، والتي لا تلتزم
بالقدر اليسير من الموضوعية التاريخية والسوسيولوجية، والهوية العربية لا تشكل معطى
ميتافيزيقي، إنها معطى إنساني يتسم بالنسبية، كما أن الهوية الأمازيغية بدورها معطى
إنساني، وهي تشكل واقعا سوسيولوجيا لا سبيل إلى إخفائه،، يؤكد أن التعدد اللغوي
والثقافي وحتى العرقي لو سلمنا بذلك جدلا، هذه المعطيات تشكل واقعا لا يرتفع، ولا
سبيل إلى محاولة تأكيد غير الحقيقة التاريخية والاجتماعية.
إن هاجس الهوية الواحدة، المنفردة، الوحيدة، ظل يلازم العرب على الدوام، أينما حلوا
وارتحلوا، وهكذا فيجوز لهم أن يتشدقوا بهويتهم الخالصة، بينما لا يجوز لغيرهم فعل
ذلك، تحت طائلة مجموعة من النعوت، أدناها العنصرية، وأعلاها التحريض على التفرقة،
وبقايا الظهير البربري... وهلم جرا، يجوز لهم أن يدافعوا عن هويتهم التي اغتصبها
الأتراك العثمانيون، واستبدلوا بها الهوية التركمانية، وأسسوا لهذه الغاية المؤتمر
القومي العربي سنة 1913 بباريس،لكن لا يجوز «للبربر» في شمال إفريقيا أن تكون لهم
هوية خاصة،أو أن يؤسسوا الكونكريس العالمي الأمازيغي، لأن ذلك يعيد إلى الأذهان
السياسية البربرية لفرنسا بالمغرب، وبالتالي لن ينفع غير الاستلحاق، لأن وجود
هويتين عربية أمازيغية من شأنه من يبعث على التفرقة والفتنة وما إلى ذلك!
هذه العقدة، عقدة الهوية الخالصة، لا يعاني منها الأمازيغ فحسب، بل تعاني منها كل
الشعوب التي قدر لها أن تعيش تحت عباءة العرب، أذكر على سبيل المثال لا الحصر
الأكراد، الذين لم يشفع لهم انتماء القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي لهم،
لاعتبارهم مسلمين، وينتمون إلى «دار الإسلام»،لو جاز استعمال هذا المفهوم بشكل
عرضي،، بل إن منطق الغطرسة الذي مورس ويمارس عليهم،هو الذي جعل من الأكراد ذلك
الشعب المتمرد، الهارب في أعالي الجبال، واليوم يتهمون بالعمالة للأجنبي، وبالسعي
لتقسيم العراق وتركيا، ذلك لأنهم ينشدون الحرية، هي دون غيرها التي ستمكنهم من
انتزاع حقوقهم في العيش بكرامة على أرضهم، كشعب له مقوماته الحضارية المتميزة،أما
مقولة الانتماء إلى»دار الإسلام»، فلم تجر عليهم غير الويلات والوبال.
إن إشكالية الهوية في البلدان المغاربية لا يمكن حلها بالهروب إلى الأمام، وذلك
باعتبار المغارب، منطقة عربية، وانتهى الأمر، يتطلب الأمر التعامل بشجاعة مع كل
المعطيات، والحقائق البشرية والتاريخية، والسياسية، والإقدام على حل الإشكاليات
المرتبطة بها، في إطار الاعتراف المتبادل، بحقوق الشعوب في أن تعيش بكرامة، وفق
القانون الطبيعي، على أرضها، مستعملة لغتها، وثقافتها، مستفيدة من خيرات أرضها،
والبداية يجب أن تكون مع مساءلة الذات، حول جدوى طمس الحقائق، والجحود الأعمى بها،
الحقيقة الأولى التي يجب إعادة النظر في مسلماتها، هي أن بلاد المغارب ليس منطقة
عربية وحسب بل يتعايش فيها العرب، والأمازيغ، والأفارقة، واليهود، وعلى هذا الأساس
فلا مسوغ بقي بعد ذلك لتسمية المنطقة بالمغرب العربي، بل يجب أن تسمى
بتسمية:»المغرب الكبير»، أو : «شمال إفريقيا»، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تسمى
في أدبيات الحركة الأمازيغية بتسمية: «تامازغا-Tamazgha»، كرد فعل على هذا الإقصاء
التعسفي.
ثانيا: مصطلح:»المغرب العربي»و أسئلة الحداثة السياسية:
1 -سؤال الديمقراطية:
إذا كانت المواطنة-Citoyenneté تعتبر إحدى ركائز الديمقراطية، فإن»الديمقراطية»في
منطقة البلدان المغاربية لا تزال تفتقر إلى هذه الركيزة الأساسية، هذا إذا أمكن
الاعتراف بوجود أي نوع من أنواع الديمقراطية أو الانتقال الديمقراطي بهذه المنطقة،
ذلك لأن المناخ السياسي السائد لا يشجع على انبثاق أفكار التسامح-La Tolérance،
والاعتراف بالأخر، ذلك المناخ السياسي الذي ساهمت في تكريسه عدة معطيات، تاريخية،
اقتصادية، سياسية واجتماعية، فاعتقاد العرب المغاربة، أو المستعربين المغاربة، أنهم
جزء من الأمة العربية، هو الذي يحول دون بروز فكر الانفتاح والتسامح، هذه النتيجة
سوف تؤدي بنا إلى التساؤل عن الأسباب، اعتقد أنه يمكن تلمس هذه الأسباب انطلاقا من
ثلاثة مستويات:
1.1.2-المستوى الفكري النظري:
ويعني أن عدم بروز أفكار سياسية حداثية، أو على الأقل عدم القدرة لدى الأنظمة
الحاكمة في المنطقة، والنخب السياسية على أن تستفيد من طفرة الحداثة السياسية في
العالم الديمقراطي، هو الذي جعل المناخ السياسي لدينا، لا يزال مثقلا بالأهواء
الفاسدة، القادمة من سلوكات الاستبداد السياسي، وعدم تبلور مقاربات فكرية، سياسية
واجتماعية، تلائم طبيعة المجتمعات المغاربية، في خصوصيتها الإثنية، والثقافية،
والاجتماعية، يؤدي إلى الارتكاس في شرنقة الماضي، ماضي الأمة العربية المجيد. صحيح
أن الكل صار يتغنى بالديمقراطية ومزاياها السياسية، والكل ينشد تطبيقها في كل بلد
من البلدان المغاربية، سواء من الأنظمة الحاكمة أو الطبقات السياسية، والثقافية،
غير أن الواقع يؤكد أن الأفكار الديمقراطية التي قد تلائم خصوصية هذه الشعوب، لم
تتبلور بعد.
2.1.2- المستوى الإجرائي والمؤسساتي:
أي أن غياب الجرأة السياسية لدى هؤلاء على مجابهة الإشكاليات المترتبة على تدشين
الانتقال الديمقراطي، بمعنى القدرة على أجرأة الانتقال من مستوى شخصنة السلطة، إلى
دولة المؤسسات هو الذي يجعل كل الأشياء تراوح مكانها، بالرغم من الخطابات الرنانة
حول الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، التي أثقلت أسماعنا بها الخطابات
الرسمية، ووسائل الإعلام المغاربية.
3.1.2- المستوى التطبيقي العملي:
يؤكد هذا المستوى أن ثمة إشكالية عويصة تعيشها شعوب المنطقة، هي إشكالية تطبيق
الديمقراطية، فلماذا لم ينجح هذا «الغرس»في التربة المغاربية؟ بالرغم من كل
المحاولات المبذولة لخلق الظروف الملائمة، لنموه وازدهاره؟، هل الأمر يعود إلى
طبيعة هذه الشعوب، وعدم قدرتها على استيعاب درس الديمقراطية، وركونها إلى الاستبداد
السياسي، واستساغته؟، وبهذا الصدد أستحضر، مقالة الفيلسوف الفرنسي، أتين دي
لابويسيه،»بيان في العبودية المختارة»، حيث يوضح بشكل قاطع أن ميل الشعوب إلى
الاستبداد وركونها إليه، هو الذي يجعل المستبدين يستسيغون بقاءهم مستبدين، بينما
تستمر تلك الشعوب المذلولة في إذلال نفسها لأولئك الحكام المستبدين.
غير أنه يمكن طرح السؤال الأنف بصيغة أخرى هي: هل الأمر يعود إلى إكراهات السلطة،
وعدم قدرة الحكام على التوفيق بين متطلبات الانتقال الديمقراطي وقيادة هذه الشعوب
الجاهلة والفقيرة والجائعة، والتي من الممكن لو تذوقت حلاوة الديمقراطية، أن تتمرد
على حكامها مطالبة إياها بالمزيد من الديمقراطية، وأخيرا هل الأمر يعود إلى طبيعة
الديمقراطية كفلسفة للحكم التي لا تسمح بانبثاق التجربة في غير الأرض التي انبثقت
منها أول الأمر، هذه الأرض هي:»الشمال»؟
أعتقد أنه ما لم تتبلور أفكار سياسية حديثة تستلهم روح الفلسفة الديمقراطية، في
«الجنوب»،مع ضرورة وجود رجال لديهم الإرادة السياسية الملحة والأكيدة في تطبيقها،
لن ينجح غرس الديمقراطية في تربة الجنوب، حتى ولو هيأنا جميع الظروف الملائمة له،
ثمة نسقان حضاريان مختلفان، هذه حقيقة فلسفية وعلمية، وفي داخل نسق الجنوب، أنساق
متساوقة، النسق المغاربي واحد من هذه الأنساق-Systèmes ، أعتقد أنه يلزم انبثاق
وتبلور مفهوم الدولة-الأمة-Etat-Nation، داخل النسق السياسي المغاربي، ليس تماما
بالشكل الذي تبلور به في الغرب،إلا أن تبلور هذا المفهوم من شأنه أن يساعد الشعوب
المغاربية على فك الارتباط بالمشرق بادئ الأمر، ومن ثمة إعادة تأسيس العلاقة مع
المشرق في إطار نوع من التوازن، لن يبقى فيه للمشرق الثأثير الكبير على المغرب، بل
سوف تؤسس العلاقة الجديدة على نوع من الاعتراف المتبادل، دون السعي إلى الاحتواء،
أو الإلحاق.
لنجري هذه المقارنة بخصوص إشكالية تطبيق الديمقراطية، من الناحية المؤسساتية، ونعود
لطرح السؤال التالي: لماذا لا تسمى أوربا اليوم، أوربا اللاتينية أو أوربا
الجرمانية مثلا؟ ولماذا انضوت جل القوميات واللغات والثقافات الاوروربية في ظل
مؤسسة ذات تسمية لا تحيل على أي معطى عرقي هي: «الاتحاد الأوروربي»، لعل الإجابة
على هذا السؤال يمكن إيجادها بشكل بديهي في التعاون الاقتصادي القائم بين مختلف
الدول الأوروبية، غير أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، إنه يرتبط بمأسسة الديمقراطية،
أي بتطبيقها أفقيا من خلال انبعاث وتوسع جل المؤسسات الأوروبية من وفي الشعب،
وعموديا من خلال الصعود والهبوط المتبادلين للميكانيزم التمثيلي من وإلى المؤسسات،
وتشرب أوربا كجزء أساسي من المنظومة الغربية بفلسفة حقوق الإنسان، والمواطنة، ودولة
القانون. فهل تشربنا نحن في المغرب الكبير بفلسفة حقوق الإنسان.
2-سؤال حقوق الإنسان:
تقتضي الممارسة الديمقراطية، الانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة المؤسسات، هذه
الأخيرة ترتكز على المواطنة وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، فإذا كانت
المواطنة-Citoyenneté، هي دعامة حقوق الإنسان في دولة المؤسسات، وفي ظلها يتمتع
المواطنون بحقوقهم الطبيعية كاملة غير منقوصة، ويحترمون واجباتهم إزاء الدولة
والمجتمع، فإنه يحق لنا قبل معرفة ما إذا كانت الشعوب المغاربية تتمتع بحقوق
الإنسان أم لا، معرفة نوعية وطبيعة هذه الحقوق، وهل هي نابعة من تطور الوعي لدى هذه
الشعوب بأهميتها أم تم استيرادها فقط كما تستورد مختلف البضائع التي قد لا تحتاج
إليها إلا فئة معينة من المجتمع، فتبقى في محلات التخزين حتى تنتهي صلاحيتها، إنه
من البديهي أن تستفيد شعوب الجنوب من التقدم الحاصل في الكون في بلورة منظومة حقوق
الإنسان، إلا إنني اعتقد أن فلسفة حقوق الإنسان شأنها شأن الديمقراطية، ما لم تنبع
من حاجة المجتمع الماسة إليها لن تكون بدورها سوى شجرة غير مثمرة توضع للتزيين،
الظاهر أن الدول المغاربية تتنافس على تأسيس وزارات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق
الإنسان، في حين، هذه الفلسفة انبثقت في الغرب من القاعدة لتصل إلى القمة، وليس
العكس، فإذا كانت مثلا الحقوق اللغوية والثقافية تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة
حقوق الإنسان التي تشمل مجموعة من الحقوق، كالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية،
والسياسية، فإن اعتبار البلدان المغاربية، منطقة عربية، وذلك بتسميتها عنوة
بتسمية:»المغرب العربي»هو مصادرة صريحة لهذه الحقوق، إذ أن المنطقة يتعايش فيها إلى
جانب العرب أو المستعربين، الأمازيغ، واليهود، والأفارقة !، فهل تفطنت المؤسسات
المغاربيية التي تعنى بحقوق الإنسان إلى هذا الخطأ المنهجي في صميم عملها الحقوقي؟
يرجى أن تعمل هذه المنظمات على تدارك هذا الإجحاف الحقوقي الخطير، والذي يشكل مسا
خطيرا بحق من حقوق الإنسان، الأساسي والأهم قبل أي حق آخر، إنه الحق في المواطنة.
أعتقد أن ثقافة حقوق الإنسان، لم تلقن بادئ الأمر للناس في الغرب في المدارس
والجامعات،بل ناضلت تلك الشعوب من أجل انتزاع تلك الحقوق، بمعنى أن استشعارها
لحاجتها الماسة لتلك الحقوق هو الذي دفع بها إلى أتون المواجهة مع الاستبداد، فهل
استشعرت الشعوب المغاربية حقيقة بحاجتها الماسة إلى حقوق الإنسان؟، أعود إلى
إشكالية الأنساق-Systèmes رابطا إياها بمشكلة عدم استطاعة الشعوب المغاربية -كجزء
من شعوب الجنوب، باعتبار الخلفية الدينية والثقافية السائدة -الحسم في هذه المشكلة،
وذلك بتقرير أن لا سبيل إلى ربط منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا،
بمثيلتها الواردة في مختلف النصوص الدينية، والتي تمارس تأثيرها الكبير على هذه
الشعوب، باعتبار أن حقوق الإنسان منصوص عليها في النص الديني، ولهذا تركت هذه
المشكلة لنوع من الارتجال السياسوي الذي يراهن على تلميع الواجهات، وذلك بمحاولة
إعادة تصنيع السلع ذات الجودة العالمية، محليا، وبمواد أولية محلية، وهو نوع من
تزوير الماركات، للتمويه على المستهلك المحلي، الذي سوف يعتقد أنه يقتني فعلا
السلعة المعلومة ذات الجودة العالية،وهو في حقيقة الأمر يشتري سلعة مزورة وبنفس
السعر. بتعبير آخر، إعادة توطين المفاهيم التي تأسست عليها فلسفة الديمقراطية في
الغرب،وأقلمتها مع الظروف المحلية، ومع العقلية المحلية، التي تؤكد المعطيات
المجتمعية أنها لم تستوعب بعد ثقافة حقوق الإنسان،أعتقد أن المدخل الأساسي السليم
لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في واقع الشعوب المغاربية، إشاعة ثقافة التسامح-La
Tolérance،وذلك يقتضي إعادة النظر في العديد من المسلمات التي تعتقد الدوائر
المستفردة بالقرار المغاربي، والتي تتبنى الفكر الأحادي/ الإقصائي، أنها تمثل
الحقيقة التاريخية، والاجتماعية، والثقافية، للمنطقة المغاربية، من بين هذه
المسلمات، مصطلح «المغرب العربي»، الذي يشكل مصطلحا عنصريا واضحا،لا يترك المجال
لالتماس أي عذر لتلك الجهات التي لا تزال تعتقد أنه من صميم الحقيقة المطلقة التي
لا تقبل المراجعة،هذه الحقيقة، التي ليست بدورها إلا وجها من أوجه الاستبداد
السياسي.
|