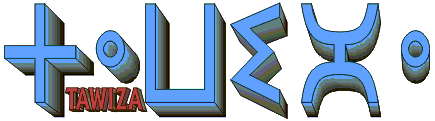 |
uïïun 174, mrayur 2961 (Octobre 2011) |
|
|
|
اللسانيـات الدينية أو ما في الجبة إلا الشيطان
بقلم: أُبوبكر عبد الرحمان Amazigh fdoux
«وباسم قراءة معينة للقرآن سوف تطور نظرية عرقية تحاول إثبات تفوق العربية على غيرها من اللغات» (لويس كالفي).
المدخل: لمحاولة الوقوف على «الجبة اللسانية الدينية» هذه سنستضيء ببعض المواقف الدينية السلفوية «الوهابية» التي تميل كل الميل لملء هذه الجبة وفق تصورها، ويندرج عملها ذاك ضمن موقفها العام من اللغات في أدبياتها الدينية أو المنهاجية حسب تقوقع تصوراتها غير الواضحة على مر تاريخها، ولن يكون الأمر سهلا ما لم يتم تفكيك العملية الدينية ـ الشرقية خصوصا ـ برمتها وتحليل علاقاتها المتعددة، بالدين، بالسياسة، بالوسط، نزولا عند علاقة «رجل الدين» بالله والسلطان والمجتمع، ومحاولة إعادة القراءة للموروث السلفي الديني»النصي» ومحاولة بناء «موقف رسمي» لها في «اللغات»وسياسات اللغات ووظائف اللغات، وكل ذلك يستلزم المرور بطبيعة الموضوع ككل، إذ نجدها ملخصة في قدسية مغلقة ومنغقلة على ما يمكن أن يبني قدسيات أخرى تشاركها المعبد القدسي نظرا لاشتراكها مع غير المقدس (المدنس) في نسق واحد، لأن «الانسان المتدين لا يستطيع العيش إلا في مناخ مشبع بالقداسة»( ميرسيا الياد، المقدس والمدنس، ترجمة :عبد الهادي عباس المحامي، ط الأولى 1988، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، ص 30) مع العلم أيضا أن «الغالبية العظمى ممن «لا دين لهم» ليسو محررين بمعنى الكلمة من التصرفات الدينية والتيولوجيات والميتولوجيات. إنهم مغرقون أحيانا بركام سحرـ ديني، وإنما هابط إلى درجة الكاريكاتير، ولهذا السبب من الصعب أن يكون قابلا للاعتراف به» (نفسه، ص: 149) ولا يكاد القارئ أو المحلل يتبين أبعاد «هذه القدسية» في النظرة الأولى أو الثانية، خصوصا أن المجتمعات المتدينة والشعبية لا تسمح لنفسها في الغالب بإعادة طرح التساؤل حول القضايا التي بت فيها رجال الدين حسب الوسط الاجتماعي وطبيعته وكيفية تدينه، وتعود مهمة التنوير وطرح التساؤلات مهمة ثقيلة الكلفة على أكتاف المفكرين بفئاتهم، مع التزام العمل على تفكيك وخلخلة المرجعيات التي تكبل العقل المجتمعي بميتافيزيقا القداسات ونواميس التقديسات وأرواح المقدسات العبثية المجانية، بله أن القدسيات تلك قدسيات متوارثة، فمن قدسية ـ حقة للكتب المنزلة ـ إلى قدسية اللغات المنزل بها الوحي (لغات الوحي) إلى قدسية «حروفها»، إلى قدسية «أقوامها» مع العلم أن «الله لم يتخذ لغة رسمية يجبرها على عباده دنيا وآخرة، كما أنه «تعالى» لم يتخذ صاحبة ولا ولدا» ردا على من يريدون أن يكونوا أبناء الله وأحباءه من اليهود والنصارى و»العرب أيضا، ومن اتبع «هدى» عروبتهم من «المسلمين غير العرب.وفي تناولنا للموضوع، سنقوم بجرد بعض المعطيات «النصية» حول مواقف رجال الدين ـ وليس الدين ـ من اللغات في وضع سوسيوـ لغوي متعدد، أو بكلمة واحدة، «موقف علماء السلفية وفقهاء الدين الإسلامي من التعدد اللغوي ، سواء عندما يتعلق السياق بمزاحمة اللغة العربية في بيئة تسيطر فيه العربية أو في سياق آخر يضعف فيه استعمال العربية، وهذا ما أسميناه هنا «باللسانيات الدينية» كمصطلح «إسنادي» أنجره نجرا مما يتساقط من «خشب»رجال الدين وأوصيائه على»عقل بعض المجتمعات»الدينية التقليدية ... وتأتي «اللسانيات الدينية» كمصطلح ضمن اللسانيات الاجتماعية، نظرا لتوظيفه المتعدد ووقوفه أمام أزمات لغوية عدة، تبقى مكبوتة وراء «الصلا(ة) والسلام»... وقبل الوقوف على تلك المواقف بطبيعتها التقليدية، يجدر بنا أن نمر بمعبر لساني ممتد في تاريخ اللسانيات عامة، والذي قسمت فيه اللسانيات بمرجعية دينية «سامية قومية» إلى «لغات سامية ولغات حامية في الدرجة الثانية، وهي المرجعية التي لم تدم «موضوعيتها» في خضم التطور العلمي للسانيات... فكانت اللسانيات الفرنسية ـ إقليميا ـ أول من رفض القول بأصل اللغات ونشأتها، فحين «أسست جمعية اللسانيات Société de linguistique de Paris في باريس 1866، نصت المادة الثانية من نظامها على ما يلي: (لا تقبل الجمعية أي عرض يتعلق بأصل اللغات، أو بإنشاء لغة عالمية شاملة). ويندرج التصنيف السامي ـ الحامي للساني الألماني ـ التاريخي ـ شلوتزر Schlozer عام 1781 ضمن ذلك، مع العلم أن هناك من اللسانيين من اعترض على ذلك الرفض الفرنسي. مع العلم أن السند الأساسي لبناء مصطلح «اللغات السامية» لدى شلوتزر كان ذا مرجعية تاريخية دينية غير لسانية أساسا، مما جعله منفتحا على عدة ثغرات سواء في قراءته لجدول أنساب أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث أو في اعتماده أصلا لهذا البناء النظري اللساني، نظرا للقراءات الإقصائية التي أَقصي بسببها «الكنعانيون» في جدول الأنساب من طرف بني إسرائيل «مع أنهم يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من الصلات العنصرية واللغوية المتينة» (إسرائيل ويلفنسون، تاريخ اللغات السامية، ت: لجنة التأليف والترجمة والنشر، سنة 1914، ط 1.ص:2، عن بروكلمان). ورغم القوة التي فرض بها مصطلح الساميات نفسه في تاريخ اللسانيات، فإنه يبقى نسبيا، إن لم نقل كما علق إسرائيل ويلفنسون أنه «من العبث إطالة البحث في أمر غامض مجهول نشأ ونما في عصور سبقت العصور التاريخية» (المصدر السابق ص:4). وقبل ذلك بكثير كانت قصة أخرى لم يمت صداها في اللسانيات والقراءات «الدينية» للسانيات ـ إلى الآن ـ تحكي عن «الوحدة اللغوية المطلقة» والأَولى أول الخلق كما تحكي «النصوص الدينية أو «الميثولوجيا الدينية المسيحية عبر نصوص واضحة تحاول أن تفسر التعدد اللغوي الطبيعي للبشر وتعده كعقاب للبشر من قبل الله. مما لا يستطاع التحقق منه لوقوعه ما قبل التاريخ في حقب ليست عليها شهادة (كالفي لويس). فلو رجعنا إلى تلك النصوص الدينية ـ الميثولوجية ـ المسيحية لوجدنا الحكي يحكي واضحا حول «أسطورة الأصل الواحد» لكنه يستبطن بعدا قدسيا ـ بحكي ديني ـ أو مظهرا تفوقيا ـ بتعبير اجتماعي ـ ولذا تضطر تلك القراءات الأسطورية في قراءة ثانية لسياق «الأصل» إلى تحديد «اللغة الواحدة المعنية «بذلك الأصل لاستحالة «الثنائية أصلا، لتخلق ناموسا آخر غير تاريخي، وهو ناموس «القداسة الأولانية الأصلية أو الوحدانية الأزلية المطلقة» وبذلك «تكتيكا» يتم الحصر الأول للغات، وتقسيمها بعقل أسطوري إلى «لغات دينية» و»لغات غير دينية» ويبقى الميدان خاليا إلا من لغتين اثنتين أو ثلاث أو أربع على الأكثر، ليبقى العدد وفق التسامح ـ على الرقعة ـ أو التوافق أو حتى التقارب المفترض بين تلك اللغات، تقاربا أسريا أو دمويا أو معجميا أو دينيا أو حتى جغرافيا حسب الأذواق الدينية تلك، وفي المرحلة هذه يتم المرور ـ تلقائيا ـ إلى الإشعار بتفوق القوم أو الشعب المتحدث تلك اللغة ... ومن ثمة تقديسها ـ بمنطق تراتبي ـ دون المعنيات معها في مربع التقديس أيضا، وبذلك نعود إلى «النواة القدسية الأولى» في تعلمنا لتك اللغة أو نكفَر عن «العصيان» المتمثل في «التعدد اللغوي البشري» فهل نحكي في ألسنتنا الأسطورة ؟؟؟ من خلال تصفحنا لـ»الكتاب المقدس» المقسم إلى أسفار عدة، نصادف ـ حسب التقسيم التاريخي الديني ـ سفر التكوين، معنيا في اسمه ودلالته المعجمية أيضا بالأصل والبداية والابتداء والمركز، (تكوين الخلق، اللغة...) ولا عجب إذن أن يستهل بفرضيات الأصل، الوحدة، تقول الآية الأولى منه: «وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة»(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الاصحاح 11). أفلا نجد تفسير ما قلناه بداية من تكتيك القراءات الدينية للوصول إلى تحديد ما بغاية «تفوق قومي» ما في متابعتنا للنصوص الدينية تلك؟ ، فهذه «الآية» السادسة تبني نفسها على منوال الآية الأولى محاكية تركيبها ونسقها النحوي، يقول الرب: «هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم للعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه»(المصدر نفسه، الآية:6) وعلى هذا تكون الآية السادسة من سفر التكوين تفسيرا للغة المعنية بأسطورة الأصل وهي اللغة العبرية المسؤولة عن حس التعالي اجتماعيا، وتحقق في الآن نفسه تأويلا يصرف أذهان الآخرين عن التفكير فيما وراء ذلك، ليجمع «تشتتهم» الذهني في قضية لغة الأصل، ويحدد الجنس بقوله : «هوذا شعب واحد» وأرى أن لا تخلق المسافة الإملائية في الآية السادسة بين «هو» (كضمير المنفصل) وبين «ذا» حتى لا يظن أنه «ضمير وإشارة»، (أو يتم الحسم بين الدال المهملة والمعجمة في كتابة «هوذا» في الكتاب المقدس ؟) ألم يكن هناك ترتيب سابق لشعب الله المختار وهو يستعد للمبارزة التفوقية الجنسية المضمرة في الميتافيزيقيا اللغوية اللسانية منذ بداية البداية ؟ لم لا؟ وهم أهل كتاب في النسق الديني الإسلامي أيضا ... المعادلة معقدة تماما منذ البداية، فالنصوص تخلق نفسها بعد موت النص ـ التوراتي ـ الأصلي، وتقوم التأويلات الدينية بشق مسار اجتماعي لنفسها من خلال ما ترصصه في شكل جمل وآيات ونصوص، لتكون هي المدخل الرئيسي لمعركة الدخول إلى المعرفة الإنسانية عموما ومحاولة امتلاك الحقيقة ـ الغيبية ـ بالجملة، ليتم صرف عملتها في سوق المجتمعات وبيعها بالتقسيط لمن يستطيع تسلق «مدارج» علماء النص القدسي ليشكل بدوره مركزا يتربص بالمجتمع ويصرف له من آياته على شكل صكوك غفران أو بيع بقع الجنة لـ»عامة» الشعب/الشعوب، «فقد كان أحبار اليهود في العصور القديمة يعتقدون أن اللغة العبرية هي أقدم لغة في العالم، وسرت هذه العقيدة من اليهود إلى غيرهم من «الساميين» حتى أن العرب في القرون الوسطى كانوا يعتقدونها» «(اسرائيل ويلفينسون، م.س، ص 6 ـ 7) وكان نتاج التقسيم السامي ـ الحامي مصوغا كله بالأيديولوجية الدينية التي يتولى «الأحبار» والكهنوت أمر تصريفها في الناس. علما أن بنوة «سام» وبنوة «حام» واحدة أصلا، ويمكن أن نتساءل بناء على جدول»الأبناء الأصل» عن موقع اللسانيات «اليافثية» و»الكنعانية»(يافث، كنعان)؟ ثم نتجه غرب التأنيث لنتساءل عن «اللغات المؤنثة» إن كان للنبي نوح بنات أم لا ؟؟؟ أم أن اللسانيات الذكورية خلقت في البدء وستبقى؟ وهل نتجه في قراءة أخرى إلى لسانيات الكفر والإيمان؟ إيمان سام مثلا، وكفر حام؟ وأيهما (أيهم) المعني حتى في القرآن نفسه بنداء نوح في حادثة الطوفان «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» (‘سورة هود، نهاية الآية 42، القرآن). فأين يمكن أن ترسو «سفينة» نظرية التقسيم السامي الحامي؟؟؟ وهل هناك من «جودي» لساني علمي لتستوي عليه، ولتعد الحياة إلى اللسانيات بعد «طوفان» القراءات الدينية، ليقال لها بعدئذ «بعدا لها»؟ أم أن كل شيء نشاهده الآن في الدنيا كان قد قضي فيه أيام الطوفان، حتى أنه سئل «أمير المؤمنين فقال: ما بال الماعزة مرفوعة الذنب بادية الحياء والعورة؟ فقال: لأن الماعزة عصت نوحا لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبها، والنعجة مستورة الحياء والعورة، لأن النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح عليه السلام يده على حياها وذنبها فاستوت الإلية». (العلامة المجلسي، قصص الأنبياء، حققه واعتنى به محسن عقيل، دار المحجة البيضاء، ط 1. 2007 ص:147) فكيف يكون «عصيان الماعزة» لنبي الله «نوح»عليه السلام وهي عجماء؟ وكذلك كان أمر الحمار الذي اتخذ للخدمة الدنيوية الأبدية، فقد كانت قصته القدرية المقدورة زمن نوح، حيث إن «نوحا عليه السلام، لما أدخل السفينة من كل زوجين اثنين جاء إلى الحمار فأبى يدخل (هكذا) فأخذ جريدة من نخل فضربه ضربة واحدة وقال له (بالسريانية) «عبسا شيطان» أي أدخل يا شيطان». (العلامة المجلسي، م,س. ص: 152 ـ 153) أم أنه أوتي نوح عليه السلام في مثل هذه القراءات «منطق الماعز والنعاج»مثل ما أوتي سيدنا سليمان عليه السلام «منطق الطير»؟، وفي ظني الحائر أن حكاية اللسانيات بالنظرة السامية الحامية عولجت بالمنطق نفسه. وفي الحكي كله لمسة «دينية» أسطورية ذات حدين اثنين الحد الأول موظف في: «العذاب/الطوفان/ظهور عورة الماعزة/غرق أحد أبناء نوح، ولن يكون إلا حام ـ تقريبا ـ وتقهقر «الحاميات»الخ... في مقابل الحد الثاني المتمظهر في: النجاة/ستر عورة النعجة/نجاة سام وتفوق «الساميات»، وفي النسق نفسه، لن يكون راعي الماعزة المرفوعة الذنب، البادية العورة، «السوداء»بالضرورة ـ استقراء ـ إلا «حام المسخوط»، ويكون «سام» رب «النعجة» الطائعة البارة البيضاء»بالضرورة أيضا. وهذا ما يمكن تتبعه في المرجعيات السلفية الإسلامية أيضا في شقها السني والشيعي وغيرهما، فكيف التطلع إلى أفق أوضح للسانيات في المرجعيات الدينية؟ سؤال نتركه هنا لعماء القراءات الدينية هذه والتي يربط بعضها ببعض، مللا ونحلا، مذاهب ومشاعب، إسرائيليات وتكهنات...الخ. بغض النظر عن مرحلة ما بعد «التواضع» النسبي اللساني التاريخي على المصطلح السامي ـ الحامي، المتمثلة في دراسة أصواتها بمختلفها ومقارنة الساميات وتفرعاتها بعضها ببعض كمقاربة علمية افتراضا... وتعقب هذه القراءة كرونولوجيا ظاهرة لسانية أخرى ـ طبيعية ـ في النسق اللساني، وغير طبيعية في القراءات الدينية لاختلاف طبيعة السبب والخلفية وراء وقوع الظاهرة نفسها في القراءتين، فبعد زمن «الوحدة اللغوية الإطلاقية» تأتي الآية السابعة والثامنة والتاسعة من سفر التكوين لتخط للبشرية «ظاهرة البلبلة» اللسانية ـ التعدد اللغوي ـ جراء غضبة من الله على أول مجتمع بشري أراد أن ينظم نفسه، تقول الآية السابعة: «هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض» ويكون الأمر، كما تقول الآية الثامنة «فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة» ومن هناك يستند سفر التكوين إلى أصل كلمة «بابل» وزمن بنيانها كما توحي بذلك الآية التاسعة: «لذلك دعي اسمها (بابل). لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض.» (الكتاب المقدس، سفر التكوين، الإصحاح 11) إن هذه القراءات التوراتية هنا وفي مجملها تعطي ـ في منظورها ـ لعدد كثير من الظواهر تفسيرات عدة، فمن ذلك، إعطاؤها معنى لكلمة «بابل» وهو «معنى البلبلة والتشتت اللغوي» وهو «اشتقاق زائف يجمع بين لفظ «بابل» وفعل «بلبل» (بالل بالعبرية) الذي يعني في العبرية ( وهم، والتبس عليه الأمر)، في حين أن لفظ بابل يرجع في حقيقة الأمر إلى «باب إيلي» الذي يعني «باب الله» والذي جاءت منه بلاد بابل (Babylone)»(لويس كالفي، م.س، ص:64) وتبقى ظاهرة «البلبلة» قبلة لعديد من المصطلحات اللغوية القائمة على روح «الشتات» الأول، ومنه لفظ «البلقنة» الذي لم يخل في معنى من معانيه من «روح اللعنة التعددية اللغوية الشتاتية التشردمية» ويتم التعامل مع هذه الظاهرة ـ اجتماعيا ـ «باعتبار اختلاف اللغات دليلا على عدم المساواة فيما بينها، فالغرباء برابرة عند أهل أثينا لأنهم لا يتكلمون الإغريقية. (التشديد من المصدر) ويعج التاريخ بعبارات تدل على عدم تقدير لغة الآخر»(لويس كالفي، م.س، ص:66) ومن يدري؟ فقد تكون للفظ «البربر» كاسم دخيل أطلق على الإنسان الأمازيغي من طرف الآخر علاقة بهذه البلبلة اللسانية التاريخية، ويقربنا إلى ذلك أيضا، التقارب المخرجي لحرفي «اللام والراء» في كل منهما وتضايفهما أحيانا، وتكون «البلبلة»و»التبلبل» هو «التبربر» (إبربورن) بحمولة «الغربة» والشتات» بل يمكن الذهاب لأبعد من ذلك ونفترض بعقل لغوي أن «باب إيلي» كلمة أمازيغية أصلا، لأن «إيلي أو إيلا» لفظة أمازيغية أيضا تطلق على «الله» (ألله ليس لفظا عربيا) أو «أكوش» فيكون «باب إيلي» هو الباب الآخر إلى دخول «مدينة الله» للقديس اُوغوسطين اللاهوتي الأمازيغي المسيحي، وتكون الأخيرة معلمة من معالم وطن «أمور ن أوكوش» (AMoroccoch). ولهذه القراءة وجه في استقراء الموضوع في بابه، كما تبقى مربوطة بتاريخ اللسان الأمازيغي وتفرق لسانه اللغوي والثقافي و»تشتته» كما تشتت عقله على ألسنة متعددة و»متفرقة» في ما يمكن أن يطلق عليه الآخرون اسم «المثاقفة» ولو فقدت شروطها التاريخية كمثاقفة جادة تأخذ وتعطي... فقد يفسر هذا المعطى الكولونيالي الرسمي ـ قوة أو فعلا ـ في حقبة من الحقب باسم المثاقفة وتوزيع الثروة «الثقافية»بين «ألف الاشتراك» الممتد بين براغماتية طرف واستنزاف الآخر. وما ذلك على مكر التاريخ بعزيز. الإسلاميات السلفويات (أو الإسرائيليات السلفية): «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين»(سورة الروم، الآية 21، القرآن الكريم)، هي الآية الكريمة الأكثر ورودا على الألسنة، ألسنة «العلماء» والفقهاء سلفهم وخلفهم، وهي نفسها الآية المحفوظة سمعا لكثرة اطرادها وترددها على «طبلات «آذان المثقفين والعامة وعامة عامة العامة، حتى أنها جرت مجرى الأمثال، وسارت حيث سار مجرى النقاش العلمي واللاعلمي اللساني، ولذا تقرع آذانك مرارا من ألسنة المحسوبين على المثقفين على الشكل الآتي محرفة وهم يحاججون ويتحاجون :»إن في اختلاف الألسن لآيات للعالمين، صدق الله العظيم». آية جامعة مانعة بتعبير أصولي موجز، فيها من الإعجاز العلمي لترهات القراءات «الإسلامية السلفوية» ما يقرع آذانهم «العروبية والخوانجية» الطبع والسمت، وهي من سورة «الروم» التي كان «مضمون» بدايتها «الغلبة» حيث استهلت آياتها بفعل مبني للمجهول يقول: «غلبت الروم» وتكرر فيها عنصر «الغلبة» ثلاث مرات في آية واحدة: «غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم، سيغلبون في بضع سنين»(سورة الروم، الآية 1)، هي سورة الروم طبعا، وليست سورة «العرب» الذين نزل القرآن بلغتهم، ويكادون يرثون «الغلبة» المذكورة ـ بطريقة أو بأخرى ـ في واقع لم تجد فيه هذه الآية الكريمة وأخواتها في القرآن نفسه من ينصفها كآية كونية تعكس عملها في توسيع رقع اللغات حسب «أدنى الأرض ومقابله. ولم تجد ـ في اللسانيات الدينية ـ من ينصف اختلافها وتقديرها للتعدد اللغوي، فيقفو عندها كآية من آيات رب الروم والعرب وبني إسرائيل والأمازيغ والأكراد والأشوريين وبقية «ألوان» عباد الله. يمدون إليها ويمدون بها حناجرهم المبحوحة في مجالس و»مواقف» الاقتتال اللغوي والميز اللغوي، غير أنه بعد قول: صدق الله العظيم، ووضع نقطة نهاية الآية/الاختلاف، تعقبها استدراكات تحد من «نصيتها وقرآنيتها»، وتغيب كل القواعد من قبيل: «لا اجتهاد مع النص ووجوده» و»تليها» انطباعات شتى تخلق لنفسها مواقع تتربص بمعنى الآية نفسها قصد إسكات وضوحها في نسق خارج بالضرورة من نسق «الله المطلق» إلى النسق «الشيطاني المطلق» ومن هنا ينشأ العنوان الفرعي للموضوع «ما في الجبة إلا الشيطان» كعنوان توضيحي للأول وكقراءة نقدية «تناصية» مع مقولة الاتحاد والحلول: «ما في الجبة إلا الله» نهدف من ورائه إلى تفكيك مواقف ومرامي القراءات «السلفية»الضيقة التي جانبت صوابين معا في آن واحد. الأول: صواب المنطق الديني المؤمن بالتعدد والاختلاف اللغوي كما حدده القرآن الكريم الذي «يحتكمون إليه في أطاريحهم و»نوازلهم» «فردوه إلى الله ورسوله» رغم أنهم لا يفعلون. والثاني: صواب منهج اللسانيات الذي يدحض الطبيعة القدسية للغة/لغات دون أخرى، وبالتالي تبقى تلك القراءات السلفية ضمن «جبة شيطانية» ماردة ليست من اللاهوت ـ الدين ـ في شيء، وليست من الناسوت ـ اللسانيات ـ في شيء، ولا تخدم إلا إطارها المهيكل نفسه في حدود «قدسية» موهومة (قدسية الإنسان أو شيء من ذلك القبيل) أو حتى عبادة من يطلقون على أنفسهم «ظلال الله في أرضه» ممن «يخطبون» ولا يدرون لمن يخطبون وما يخطبون، فهل أوحى لهم بذلك الشيطان؟؟؟ فـ»الشيطنة» هنا وإن بالمفهوم اللغوي كما اتخذه عند ارتحال اللفظ إلى العربية تعني البعد عن شيء أو «البعد عن الله» تماما كما تفعل هذه المواقف السلفية الإسلامية في بعدها عن «اختلاف الله» وعدم تقديسه منطوقا أو مفهوما لأي لغة ولا لأي حرف ولا لأي دم أو شعب، وهم بذلك يرحلون «إلى ميتافيزيقا الشيطان وقدسية الشيطان» في قراءاتهم تلك، دون أن نحدد «ماهية الشيطان» هنا، حتى لا نضطر لحكاية أخرى ... ونبرئ الشيطان نفسه هنا مما يقولون أو يتقولون.وفي عرضنا لبعض هذه المواقف الدينية المتشابهة حذو اللحية باللحية، والمنعكسة لروح «كسولة» تأبى الانفتاح في طلب «التعالي القدسي» على عرش الخواء الفكري المبني على «المنامات» والهلوسات» نحبذ هنا أن نبدأ بأقرب المواقف إلينا بابا ... تلك التي صيغت على شكل حوار في كتابات السي عبد السلام ياسين «كبير» جماعة العدل والإحسان و»أبيها الروحي» الذي نمذج «منهاجه» وفق أصولية دينية لا تحاورك حتى تعرب جملة تقول: «صل وتوضأ ثم تتحاور» إعرابا تاما. «الصلاة أولا، الصلاة عماد الدين، ونحن الإسلاميين لا نعرف بداية للحوار غير هذه»(عبد السلام ياسين، حوار مع صديق أمازيغي، 1997 ص:163) ولا يتحقق الحوار الاجتماعي أو «الديموقراطية الإسلاموية السلفية» إلا في مراحيض «الجامع» و»مقصورات»الصلوات»أو على «منابر النبي» كما يسميها الآخرون منهم. «الصلاة أولا، ثم نحاوركم، معشر الأمازيغ، في نضالكم الدستوري»(نفسه، ص: 162) ، وفق «قواعد الشيخ الذي «يرى ما لا ترون» مع ما فيها من مزايدات على المتحاور الآخر بالنسبة إليه، مسلما كان أو غيره ... ذلك ما كانت محاور كتاب «حوار مع صديق أمازيغي» للشيخ عبد السلام ياسين (1997) والمعني بالصداقة الأمازيغية في العنوان هو الفاعل الأمازيغي محمد شفيق، صاحب المعجم العربي ـ الأمازيغي المعروف، ويجزأ الكتاب/الحوار إلى جزأين، كل جزء لكل منهما، مع إيراد الردود والتعقيبات، وينبني حوارهما في العمق على «جزء من القضية الأمازيغية» ويستبد «الخطاب الوعظي» بنكهته الفوقية الياسينية على الحوار ككل فيما يشبه توصيات أورثودوكسية كأنها تحكي وتعيد من جديد ما سكتت عنه آيات الكتاب المقدس «هلم نبلبل ما سكتت عنه آيات سفر التكوين، ونعيدها سيرتها الأولى»نحو إطلاقية لغوية أولانية». هي ذي آيات ياسينية استتب فيها ناموس «الإلهام المنامي» في صيغته القدسية الملازمة لروح الجماعة ككل في أفق «التأحيد» المرسوم في منهاجه الوحيد الصيغة والتأويل، ولندع السفر التكويني الياسيني يعيد لنا صياغة من وحي واقعه وانعكاس الوضع اللغوي «المقدس» الطبيعة والمرام، و»لن تنالوا البر والعدل والإحسان» ما لم تسمعوا لياسين وهو يقول : ياسين ... والقرآن: «اللغة العربية من عصاها عصى الله، ومن شاقها شاق الله، ومن كفر بها كفر بالله»( نفسه، ص:96) و»عق ربه من عق لغة رسالة ربه، عصاه من عصاها، كفر به من كفر بها»(نفسه، ص:91) هي ذي تقسيمات الوحي الياسيني، وقد اتخذت شكل الآيات، في التقسيم الجملي، ومنطق «من» و»من» الذي قال فيه عمر بن الخطاب «أشعر الشعراء صاحب «من» و»من» ويعني به زهير بن أبي سلمى (بضم السين) حاكيا عن «معلقته» كأحد أهم أسلوب بلاغي قديم، واضعا باب الشرط مفتوحا أمام جواب لا مناص منه «اللغة العربية من عصاها، عصى الله...» وعلى هذا النحو تشق «المواقف» الياسينية طريقها نحو الإشهاد على جانب من القرارات السلفية الإسلامية التي تحد من «مشروعية اللغات/الضرائر» التي يتهمها ياسين ـ بدون قرآن ـ بممارستها حربا ضد «العربية» المقدسة في كل تحركاتها وسكناتها، كيف لا يكون ذلك، وقد متعها في «مشروع صرحه، ونزلها منزلة «أم الرغائب والمطالب «(نفسه.ص:115) وعلى هذا الشكل تسير خطا المواقف التوابع المتبقية التي حاور بها في»حواره» هذا، وقد جاءت هذه المواقف الياسينية مسندة في تخريجاتها إلى»القرآن الكريم» وجعلها لغة «رسمية» له بمفهوم آخر يبتغي به الياسينيون خلق كهنوت لغوي «قوماني»جامع، يجب تقديم قربان اللغات الأخرى له حتى يتحقق ويتم «حلم الخلق» ويستند هذا الكهنوت إلى إسداء «القسم» المبدئي للقيام بطقس «الإرهاب السلفي اللغوي» الذي لن يستطيع الخارجون عن المربع هذا أن «يفقهوا» إلى أين يمكن أن تركن إليه أحجار «الداما» الأساسية التي تحكم اللعبة ككل، ومن أولى البدهيات الياسينية السلفية لهذه اللعبة قول ياسين الفضيل الديموقراطي: «نشر لغة القرآن وتعليمها للشعوب العجمية واجب أن ينهض إليه «المسلمون العرب» (حوار مع الفضلاء الديموقراطيين، فقرة لغة القرآن. مؤلفاته على الموقع الاليكتروني التالي www.yassine.net ) ربما لأنها «جزء لا يتجزأ من القرآن» (حوار مع صديق أمازيغي ص:131) بطريقة أو بأخرى كما يصف ياسين أيضا، على أن علال الفاسي أسف كثيرا على عدم إتمام أجداده لرسالة التعريب «المنزلة» على ياسين في «غار ثوره هو». ومرد ذلك كله هو قوة «لو ولولا» الصنمييتين اللتين يسفسط (من السفسطة) بهما الجدال الميتافيزيقي السلفي نفسه المسند، فترى الشيخ ياسين يقول: «لولا أن اللسان العربي مصطفى مختار بين اللغات كما هم الرسل عليهم السلام مصطفين من الناس، ولولا أن القرآن كتاب الله ورسالته إلى عباده من جن وإنس بلسان عربي مبين، لما كان من يعصي العربية منتصرا للغة قومه ولهجة أمه إلا حرا يأنف من أن يستذل وجوده» (نفسه ص:96) وقد يركب هذا العقل السلفي مركب السبق الحكمي على الأشياء، فتكاد المسلمات تساقط «من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» رطبا جنيا، إن خلفية «التسليم» بوجهيها اللغويين (العامي والفصيح) هذه تبطل ـ بالكاد ـ سحر كل ما يمكن أن يكون «حوارا» أو منطقا عقلانيا أو موضوعيا في محراب الجماعات السلفية» التي لديها «الحق الذي «يزهق الباطل» أيا تكون هويته.. وبمثل الحق هذا يباشرنا الشيخ الصوفي ياسين بمعادلته القاتلة القائلة: «بما أن خدمة العربية بعلومها هي خدمة للقرآن وفهم القرآن، كان التعميم حقيقيا. وبما أن خذلان العربية واستفزازها بالضرائر وبنيات الأقلام والمحابر خذلان مباشر للقرآن واستفزاز له، كان خذلانا لخذلانه شقيقا» (نفسه. ص:97). فهل خرج ياسين عن بلاغته «الخطابية» المعهودة، الحكيمة والقوية الشكيمة؟ إن إستراتيجية هذا الخطاب هو توجيه «الترس» إلى حاجبي المحاور المتحاور باعتماد معجم ديني ـ ديني لا يخلو من وعظ مسبق الدفع، يتناول مقولة الجنة والجحيم، فمن قاموس «الكفر، العصيان، المشاقات، الخذلان ... ـ كمعجم ديني صرف ـ إلى معجم اجتماعي صرف من قبيل: المزاحمة، المنازعة، المناطحة، المنافسة، الغيرة... الخ، في نصوص تنزل بكل ثقلها على كل ضرائر اللغة العربية في أوضاعها اللغوية. «ولكن، ما بال الأمازيغية يراد لها أن ترسم في الدستور لغة وطنية ثانية؟ ما بال الثقافة الأمازيغية تغار من العربية وتنازعها على أوقات الإعلام الرسمي»(نفسه ص:83). فهل نكاد نقول على النسق القرآني نفسه «ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المفترين، على صراط غير مستقيم، لست هناك، لست هناك»؟؟؟ومن هنا يتنازع المعجمان مشروع هؤلاء «القوم» ويكادان يفضحان العنف الذي يجابه به «المجتمع» على ألسنة «حراس العقيدة والدين» إلا أن هناك ـ في نظري ـ تراتبية مفهومية في نسج هذين المعجمين، فلا يتخاللان خطيا، إذ يسبق البعد الديني ـ تكريس الكفر بالعربية وحكمه مثلا ـ البعد الاجتماعي المؤسس في مفهوم «المنافسة أو المزاحمة» كمفهومين أرضيين لا سماويين، اجتماعيين لا ميتافيزيقيين، نسبيين لا إطلاقيين... وبذلك تكون هذه «التوليفة السلفوية الإسلامية» توليفة «نصانية» تبني لنفسها قراءات سكتت عنها الديانات السماوية، ويتدارك «رجال الدين»الموقف، حتى لا «تتميع»الأسواق اللغوية، فتحاول «الفراشات» ـ كمصطلح ياسيني ـ أن يتهافتن على «سيدتهن العربية/»الفحلة» التي يلحفها ذووها من المنافحين عنها بلحاف «الضحية» التي لا تستسلم أبدا، وإنما «تأتي المطالبة الأمازيغية لتنشب أظفارها في الضحية» (نفسه. ص:100). وفق رؤية «أمازيغوفونية لا يرضى لها أنصارها إلا أن تكون في حلبة اللغات ندا وحدا» (101) هذه الأمازيغية التي يشك ياسين في اتساع «حوصلتها» لمكتسبات العقل البشري». ويبقى الطرح الموقفي الياسيني في اللغات وأوضاعها ـ إزاء العربية ـ واضحا تؤطره «القومنة» المركزية المطلقة التي يمنطقها هكذا: «فإن جاءت فراشة لغوية تركوفونية أو أمازيغية تناطح العربية بقرونها الواهية وتطير بأجنحة الأهازيج الشعرية والأمثال الشعبية السهلية الجبلية قلنا لها: لست هنا، لست هناك»( نفسه.ص:116). البعد الياسيني التجديدي لم يكن بعيد الغور في النفس التأصيلي الذي يستورده من «عكاظ» «الدولة الأمويةّ» وخيماتها ليسقطه على كل بقاع العالم رغم قصور العقلية المستوردة أمام تحديات ما يواجهه بسلاح وضعت أوزار حربه قبلاً، ولذا ماانفك يجر أذيال مصطلح «الشعوبية» التي لم تهضم «الحوصلة»الياسينية ـ على العموم ـ بعدُ مفهومها وسياقها ومزالق التفوه بها، ومحاكمة «المظلوم بنارها» وتسريح العقلية الأموية الظالمة الغازية في محكمة ترى «عدلا وإحسانا» ومرد هذا يكمن في عدم تجشم الصعاب لمعرفة «الجرح» البسيكوسيولوجي للقضية ككل، فكان طرح «الشعوبية» بهذا المعنى يهاجم الفارسي والأمازيغي والتركي والكردي والأشوري بنفس الطاقة القديمة، ولا تكلف نفسها «تبيئة» عدوها المفترض باختلاف تلاوينه وثقافاته، وتبقى الرؤية الإيديولوجية هي نفسها، دون أن يغير الزمان من سيماها شيئا. ولن نعقب هنا عليه إلا بما رد عليه في الجزء الثاني من كتابه/الحوار على لسان «صديقه» الأمازيغي: «أما «الشعوبية» التي تدينها بدون محاكمة، فلم تكن إلا رد فعل ضد العنصرية العربية. حجتي في ذلك، وهي كافية عن غيرها، أن العرب لا يزالون حتى يومنا هذا يعرَفون الشعوبية أنهم «قوم ... لا يفضلونهم (أي العرب) على العجم، فإذا كنت ترى للعرب فضلا على العجم، فاعتبرني شعوبيا»(نفسه، ج، 2 تعليقات محمد شفيق، ص:144). ورغم التأصيل الياسيني لبعض المفاهيم اللسانية الدينية المعكوسة و»المقعرة» للرؤية «البلبلية»البابلية، فإن هناك خيطا رابطا بينه وبين مواقف المشيخة السلفية القديمة التي أصبحت بدورها منغرسة في تربة «المشيخة الخلفية» الجديدة الوارثة للنهج التقليدوي ـ خطيا ـ إلى اليوم، ولعل أشهر هذه المواقف تأتي من أحد آباء الوهابيست على خط مستقيم وهو «ابن تيمية أحمد» المعروف في أوساط الفقه السلفي ب»شيخ الإسلام» لقدمه الراسخة في علوم القوم، ففي دراسة تحليلية لبعض موضوعات كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم، لمخالفة أصحاب الجحيم، في الموضوع التاسع المخصص «بالرطانة التي تعني ـ كمصطلح لساني ـ في «العقل السلفي» «تعلم المسلمين والتكلم بغير العربية» ورد ما يلي: «أما التكلم بغير العربية لغير ضرورة، فإن السلف كانوا يكرهونه أشد الكراهية، وينهون عنه، ولهم في ذلك أقوال معروفة سرد المؤلف الكثير منها» (اقتضاء الصراط المستقيم، لمخالفة أصحاب الجحيم، ت: احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقل، المجلد الأول، مكتبة الرشد، الرياض، ص:52). هذا الباب يطول البحث فيه كثيرا، نظرا للنظام الاجتماعي والديني والقومي الذي «خلق من ضلعه» ولن نستقرئ معظم ما تكرم به فقهاء «السلف» و»الخلف»على الموضوع من أطاريحهم اللاموضوعية في مجملها، غير أننا سنقف ـ في فاصل طويل لو تصبرون ـ على عتبة تجمع بعضا منهم في بوابة «الصراط المستقيم» يقول السيد ابن تيمية تفصيلا لما مر معنا في الإحالة الأخيرة في باب موسوم ب: كراهة السلف للرطانة وهي التشبه بالأعاجم في كلامهم ولغتهم. «وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني، المسمى بحرب: باب تسمية الشهور بالفارسية، قلت لأحمد، فإن للفرس أسماء وشهورا، يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهية ... كراهته (من وجه) أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء وأكثرهم في الأدعية، التي في الصلاة والذكر، أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية، وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات، هل تقال بغير العربية ؟ ... فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية، سواء قدر عليه أو لم يقدر عند الجمهور (؟؟؟) ، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية، وأما الأذكار الواجبة، فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها، وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي, وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي... وأما الخطاب بها (بالعربية) من غير حاجة في أسماء الناس والشهور ـ كالتواريخ ونحو ذلك ـ فهو منهي عنه (؟؟؟) مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرما (؟؟؟) وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه، وقال: لسان سوء (؟؟؟) وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها (؟؟؟)، وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم، وقال (إنها خب)... كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين ... حدثنا إسماعيل بن علية، عن داوود بن أبي هند، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ (؟؟؟)... وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي، حدثنا عمر بن هارون البلخي، حدثنا أسامة بن زيد عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يحسن أن يتكلم بالعربية، فلا يتكلم بالعجمية، فإنه يورث النفاق».(؟؟؟) (ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم (1/208ـ204)، يرجع إلى الكتاب الأصل، للاطلاع والزيادة، والأقواس في الإحالة مني). وفي الأصل، سنصادف أن «العربية من الدين» «ومعرفتها فرض واجب» وما يجاور ذلك... وكل هذا في آثار تخلط فيه «الحديث المدعى» بالقول «المذهبي» والرأي «الفقهي» وكلام «الصحابي» ورؤية «التابعي» وفي غياب منهجية علمية تتقصى «الخبيث من الطيب» في كل ذلك. وعلى هدى السلف الموروث هذا، تستولد مصطلحات لا هي دينية في الصميم ولا لسانية في السياق، لتنضاف إلى «الشبهات» البينية بين الدين (الإسلامي) كرسالة سماوية أرست موقفها الواضح بين اللغات، وبين اللسانيات التي انتهت هي الأخرى من نقاش مثل هذا عقيم مريض، ومن ضمن المصطلحات تلك ما يتضمنه هذا «المقطع» «وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين، وغيرها شعار النفاق، لذلك، لما فتحوا الأمصار، سارعوا إلى تعليم أهلها العربية، حتى سرت سريان النور في الظلام، رغم صعوبة ذلك ومشقته» (اقتضاء الصراط المستقيم ، تحقيق: ناصر العقل، المصدر المذكور ص:52ـ53) وإذا كانت بعض تلك الفتاوى السابقة ذات طبيعية دينية صرفة «تدغدغ الشعور الشعبوي السفلي « لأفراد المجتمع بلغة «علوية مزورة بعض الشيء»، فإن رأسا أخرى من المشروع السلفي يتخفى تحت تراب المجتمع ويراقب بعينيه الجاحظتين ما يجري فوق، من تدبيرات اجتماعية للغات ودورها في إضعاف الأمم والإيديولوجيات والمذاهب، إي ، أنها تحاول وفق منظورها الديماغوجي أن تدير الصراع اللغوي أو «حرب اللغات» لو استعرنا مصطلح لويس كالفي، أو في السقف الأعلى تعريب الشعوب لا «أسلمتها» سيرا على نهج وإرث الغزو الأموي لشمال إفريقيا في قراءة «تاريخ مجمل المغرب» (العروي عبد الله). ووفق هذه الرؤية الأخيرة يرى العقل السلفي «أنه من الخطأ الفادح مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى، في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية على العموم، والعربية على الخصوص». (نفسه، ص:53) كما يمكننا أن نجتاز في تقصينا إلى «مربع» المذاهب الأربعة لنجد فيها بالخصوص ابتداعا دينيا سلفويا عند أحمد بن حنبل ومجاوريه مذهبيا «الذي يكره التسمي (من الأسماء) بالفارسية (إي واللغات الأخرى) غير العربية. وإلا فلماذا «اللغة الفارسية» في الحقبة تلك؟ ومصطلح الشعوبية يجيب. ومن الواضح من النسق السلفي «الإسلامي» وتبنيه «العربية لغة واحدة» ومن النسق «اليهودي العبراني» وتبنيه «العبرانية» أنهما يحتكمان إلى «مركزية قارة» في عقليهما وهي مركزية «فوقانية» أو ميتافيزيقية في وجه منها، تتناول «ما نحكيه اللغة الرسمية الأولى المتبناة هي نفسها من طرف «الله» كلغة رسمية، ولعل ما أثبتته بعض المصادر الإسلامية التي تهمنا هنا، تحكي عن تجربة الوصول إلى تلك اللغة الأم للإله ـ وسبحانه ـ وغالبا ما تكون تلك المصادر منوطة بعلوم القرآن أو متناولة لتاريخيته وتفسيره، معالجة لغة الوحي، ليس في ما بعد «النزول» وإنما الوحي/الكتاب في حالتي ما قبل «النزول» و»لحظة النزول»، ونستدل هنا بما ورد في «كتاب اللغات في القرآن» من مثيل أثر يحكى: «عن ابن عباس في قوله عز وجل: (بلسان عربي مبين)، قال : بلسان قريش، ولو كان غير عربي ما فهموه، وما أنزل الله عز وجل من السماء كتابا إلا «بالعبرانية...الخ». (كتاب اللغات في القرآن، أخبر به: اسماعيل بن عمرو المقرئ عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرئ، بإسناده إلى ابن عباس، حققه ونشره: صلاح الدين المنجد، الطبعة الأولى، مطبعة الرسالة (1936). وفيما يخص تمتيع «العربية للقيام بهذا الدور «روي عن الفضيل عن الصادق أنه قال: إن الوحي ينزل من عند الله «بالعربية» فإذا أتى نبيا من الأنبياء، أتاه بلسان قومه» (العلامة المجلسي، المصدر السابق له ص:13) ونشير إلى أن هذا المصدر مصدر شيعي ـ مذهبيا ـ في كل إحالاته ومراجعه ومرجعياته (يرجع إليه) وما يهمنا هنا هو الإشارة ـ المرجعية ـ إلى هذه القراءات السلفية السنية ـ الشيعية الاسلاموية، وليس تتبعها في مظانها واحدة واحدة، ويكفي أن نأتي بنماذج حية قديمة وحديثة لتكون الند المقارن لما يمكن أن تجيب به المرجعيات الدينية بنصوصها المستقاة ـ حرفيا ـ من الكتب المنزلة كما يتداولها المسلمون واليهود، أي محاولة القيام بمقارنة مباشرة في عمودين بين ما يقرأون وعمود ما يعملون وكيف يوظفون «حلقة اللغة» في دائرة ضيقة «لحيوية» لا تتسع حتى لنقاش «المسواك «الشريف واللاشريف هو الآخر حسب «شجرة طيبة» و»شجرة خبيثة». إن النزول إلى حلبة النصوص الدينية «القرآنية» (القرآن الكريم) والنصوص «التوراتية» (سفر التكوين تحديدا) ومحاولة محاورتها في ما يتعلق بموضوع «التعدد اللغوي» بعيدا عن قراءات «رجال الدين» يضيف إلى القراءات اللسانية نكهة موضوعية عبر نحتها مفاهيم لسانية ـ تعدديا ـ في أصل قراءاتها، من قبيل مفهوم «الاختلاف» ومفاهيم أخرى مقررة في «النص» الذي يجب الاحتكام إليه أولا ومقارنته بمقولات «السلفيين والخلفويين» في دائرة ما سميناه «باللسانيات الدينية» حتى «يتبين لهم ـ هم ـ الرشد من الغي» لما ذلك من استنطاق داخلي تجديدي للعقل السلفي التقليدي المجتر والصالح «لكل زمان ومكان»، وبرجوعنا إلى الآية الواحدة والعشرين من سورة «الروم» نقرأ معهم جماعة ـ وهم يكرهون قراءة القرآن جماعة أيضا ـ قوله تعالى « ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين» (القرآن الكريم). ولن نطالب الموضوع هنا ـ والأمر سهل ـ أن يقف عند مجموع التفاسير القرآنية الكثيرة جدا والتي يجب إعادة النظر فيها أيضا لما في بعضها من إسرائليات ـ كمفهوم مرجعي إسلامي ـ وامتزاجها بأحاديث «موضوعة» تفسر بها عن هوى وبهوى حسب الأمزجة المختلفة للمفسرين، كما أننا لن نختلف في المعطى الذي تنفتح عليه الآية الكريمة التي تدحض مجمل القراءات السلفوية الواردة هنا وغير الواردة ـ وما أكثرها ـ والتي تبعد بملايين السنوات التأويلية عن المواقف المريضة التي تسقط ـ مرجعيا وواقعيا ـ على أرجلها باحثة عن «ثغرة «تبيئها» في الوسط الوسط النصوصي الديني من جهة مرجعية، وفي معترك المواقف «اللسانية، الحقوقية، السياسية، من جهة أخرى، ومن المضحك ـ المبكي في مقارنة هذه بتلك، أن القراءات «السلفوية» لا تحتسب المسافة بينها وبين آية «الروم» ولا يمكنها أن تقيم أية علاقة ممكنة بينهما، إضافة إلى غربتها عن الحياة الاجتماعية للغات وتطورها واتساع «سنامها» يوما بعد يوم، حقبة بعد أخرى، وتشهد بذا على نفسها «بشذوذها المرجعي» من فوق ومن تحت، يمينا وشمالا، وهو الشذوذ الذي يجعلها عائمة، غير ذات أية قيمة مضافة في كل الأبعاد المنوطة بالموضوع، بغض النظر عما تمارسه من «إرهاب» على عقول «الأتباع» والمجتمع الذي لا «يفقه»، أم أن «المؤسف هو أمر الناس في انصياعهم لهؤلاء، لأنها ملَكت قلبها للفقهاء، كما ملَكت عقلها، وتحسب أنه تسليم لله.. رغم أنه تسليم للكهنة ليس إلا.. هذه مشكلة الناس أبدا، الله يصب الأنبياء، والناس تشرب الفقهاء؟؟؟» بتعبير عبد الرزاق الجبران في كتابه (جمهورية النبي، عودة وجودية/توحيل التراب، ص:12)، خصوصا في المجتمعات التي تسود فيها الأمية ـ قصدا أو عن غير قصد ـ أو كلما حدثونا عن «الاستنجاء» و»أوضاعه» وضحكوا، جاز لهم أن يحدثونا عن «اللغات» ومصير الشعوب» ونصدقهم حتى لا نعكر عليهم «الابتسامة» الأولى المدمجة في حلقة «الاستنجاء»؟ بغض النظر عن وجود استنجاء «مقدس» واستنجاء «مدنس» أيضا في «مراحيض» العقل السلفي الإسلامي وهم الذين يقررون أو ينفون.وفي إيرادنا للمعجم التعددي لآية «الروم» نجد «الاختلاف» ـ وبصيغة جمع الألسن ـ مفهوما كائنا وراء «ولادة الألسن» طبيعيا عبر المكون النحوي «الإضافي» (في الآية) الذي «يخلق الألسن» ككائنات أولى كلها مجتمعة في سياقها كلغات، بغض النظر عما أفرز عنه الواقع البشري بعد ذلك من «تشتت» تلك الكائنات وإعادة صياغتها، كل حسب ظروفها و»تاريخها الشخصي» الخاص، بعد تزايد الكائن البشري وتزايد الهجرات وتداخل الألسنة وصراعها وتعايشها و»غلبتها» وما إلى ذلك مما تحوم حوله اللسانيات التاريخية ـ الاجتماعية ـ والبنيوية. ولن يكون مفهوم «الاختلاف» هنا مفهوما مستقلا عن المفاهيم التي يمكن تتبعها في «الآية»، هذه الأخيرة نفسها التي تعطي للاختلاف نكهة «تعددية» «تفصح عن نفاق القراءات السلفية» في عمقها وتفسيرها بالمعجزة التي حكمت بالتعدد اللساني تعدد النوع البشري»للعالمين»الذين تختتم به الآية «موقفها» وتقر به أحقية كل اللغة في حياتها ودفاعها عن نفسها بطرق مشروعة لا بطرق «شيطانية» تكذب به على الآية والله والرسول والمجتمع، وسنكون بلاغيين قدامى ـ مؤقتا ـ حتى نستدل بتأكيدات من قبيل «إن» وعطف «اللون» على أللسان»كعنصرين قابلين للميز العنصري «التفوقي» مدا وجزرا كما يشهد التاريخ والعصر، وارتباط «مفهوم «خلق»السماوات والأرض «بخلق» اللغات في خط واحد ...الخ. فكيف يمكن الحفاظ على «هذه الآية ـ المعجزة ـ التعددية» دون الحفاظ على «اللغات كلها» في جغرافياتها التي تكونت فيه طبيعيا دون اللجوء إلى أي تطعيم سلفوي خارجي؟ كيف يقرأ هؤلاء السلفيون «الآية ـ التعددية وهم يقومون بتزكية اللغة العربية أو العبرانية ـ وجذرهما متقارب ـ كلغتين مقدستين صراحة أو ضمنيا ؟؟؟ أفتعجز النصوص الدينية عن عبارات «التزكية التقديسية تلك، فتقدس العربية أو العبرانية دون غيرهما حتى لا تحتاج إلى جهد «الكهنوت الديني»الذي لا يمثل إلا «الشيطان/الفسوق» في قراءة الموضوع؟ ومن احتكامنا إلى تعددية «الروم» نقفز من غير خوف في الوقوع في تضاد ما، إلى مخاطبة «البقرة» التي يمكن أن نحلب من ضرع «آيتها» بعدا كليانيا موحدا للغات آدم في طابور واحد، وهنا «معجزة البقرة»التي تستطيع أن تدافع عن «آدمية اللغات كلها» عكس «الإنسان» الذي «خلق» ليفترس «الإنسان»الأخ لغة وجنسا وآدمية. تقول الآية 30 من سورة البقرة باختصار شديد «وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملآئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين»(القرآن الكريم). هذه الآية «القرآنية» التي يوافقها «سفر التكوين» (الكتاب المقدس) في بعدها الكلياني وفي الجانب المعجمي أيضا حيث يقول:»(19)وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، (20)فدعا آدم بأسماء البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية»(الكتاب المقدس، سفر التكوين، الاصحاح الثاني، الآيتين:19ـ20 ص:5و6) ..... فكيف تستقيم قراءات من قبيل أن «العربية لغة آدم، وهي أيضا لغة الجنة، وحين عصى آدم ربه جعل الله السريانية لغة له»؟ (لويس كالفي، م,س، ص: 68.نقلا عن نعمة الله الجزائري في كتابه النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين). وارتباط «اللسان العربي» بالقرآن الكريم من قبيل الآيات التي يلوذ بها «مقدسي اللسان العربي» من مثيل قوله تعالى: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا»(سورة يوسف، الآية 2، القرآن) وقوله «وهذا لسان عربي مبين» (سورة النحل، نهايةالآية 103، القرآن) أو قوله تعالى: «بلسان عربي مبين» (سورة الشعراء، الآية 195، القرآن) وشبيهها، إنما هوـ قرآنيا ـ من قبيل مراعاة البعد السوسيولغوي ـ ثقافي للمجتمع الذي يحتضن «الكتاب المنزل» على «قوم معين» بقيم معينة و»لسان معين»، تفسره الآيات الأخرى مثل «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه «ليبين» لهم»(سورة إبراهيم، بداية الآية 5، القرآن) أو قوله تعالى «ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين (سورة الشعراء، الآيتين 198 ـ 199، القرآن) كجواب عن الآية (195)السابقة عليها في السورة نفسها وسياق نزول القرآن بلسان عربي مبين. ويبدو أن نزول الكتب السماوية الأخرى والصحف والألواح»بألسنة أخرى» غير العربية والعبرية يفسر ما لم تستطع «اللسانيات الدينية» فهمه للأبد، حتى صار الموضوع ـ مبدئيا ـ مزرعة مقدسة من مزارع «المليون فتوى وفتوى» لا يدخلها إلا «العالمون» ... ويكفي أن نشير هنا إلى الوظيفة السياسية الرئيسة التي تلعبها هذه اللسانيات الدينية الميتافيزيقية، وتختزل في لعب دور الرقابة الاجتماعية والهيمنة الثقافوية والوصاية اللاهوتية على شريحة ممتدة من مجتمع يأخذ «الفتاوى التضليلية ـ ملطخة بدم من الحق قليل ـ كنصوص دينية لا يمكن الخروج عليها لأسباب عدة، علما أن الوسط الذي تسيطر فيه تلك اللوبيات السلفوية ـ كوسطنا ـ يكون مربوطا بحبل سياسي يمتد طولا من يد السلطان/ القائد/العقيد/ الفئة الحاكمة إلى «مؤخرة» رجل الدين كوسيط أمثل، يجذبه أنى يشاء، موصولا بعقليات ما قبل ـ بابلية في مزادات دينية علنية تعقد صفقاتها الحرة وتهلل لمنهاجها الذي يسمسر بها وفيها كل من هب ودب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي «معابد سياسية» تكون ملاذا «للكبت المطلق» في آخر صيحاته. ولعل هذا هو المدخل العام «البراغماتي» الذي يسوغ لما اصطلحنا عليه «باللسانيات الدينية» أن تموقع نفسهاـ أخيراـ داخل الجدال اللساني العام «المفتعل» من قبل «هؤلاء الميتافيزيقيين ومن على ملتهم» فيما يخص ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 كأحد فروع اللسانيات الآن، ويقوم المعنيون الدينيون ومن على نهجهم من «العروبيين» بأمر «تأثيث» الوضع اللساني المغربي/المغاربي عامة بإنشاء «جوطيات لسانية» جديدة مثل «الجوطية اللسانية الكيرانية» (عبد الإله ابن كيران) الخاطبة الود «الشعبي المروكي» بأسطورة «خاوا» حيث قال في كلمة له بمهرجان خطابي للعدالة والتنمية بأكوراي، ضواحي أمكناس 03 يونيو 2011 ما يلي :»العربية والأمازيغية «خاوا» (بينهما) الإسلام هادي 14 قرن» وهو يقصد «آخا» التي تعني الأخوة، فأي لحن هذا أيها «اللساني الكيراني العظيم؟؟؟ رغم أن المواقع الاليكترونية التي نقلت فيديو «خاوا» تكتب عناوين خلاف ما قال، وهو «آخا» تصحيحا لها عن حسن نية. إضافة إلى الزاوية «الياسينية» السابقة و»الشامية» (موسى الشامي) وقارعة «بوعلي» و»الفاسية الفهرية لعبد القادر الفاسي الفهري» ومدارس «حيطان مبكى السلفية» كلها إلى أسفل سافلين...فهل نستطيع ـ إلى الآن ـ أن نمسك بالحلقة المفقودة بين «حد الله» و «حد الشيطان» في قراءات رجال الدين الإسلاميين والسلفيست ؟ لنمسك في النهاية بخيوط أي «الجبتين» يحلون ويلبسون، جبة الله أم جبة الشيطان؟ ولماذا لم يكونوا صادقين «ملائكيين» ليقولوا: لا علم لنا ـ بدل الشياطين ـ فينبئونا «بأسماء هؤلاء ولغات هؤلاء»؟ لكن، كذلك كان الشيطان، أبى واستكبر للسجود/ الاعتراف لآدم، كما استكبروا «للسجود/ الاعتراف» لتعدد وكلية «الأسماء كلها» لآدم غير العربي والعبري اللذين خلقت «لغتاهما» من «نار مقدسة» وخلقت اللغات/الرطانات» الأخرى من «طين مدنسة». Ouboubker Abderrahmane Amazigh fdoux amazighfdoux@gmail.com
|
|